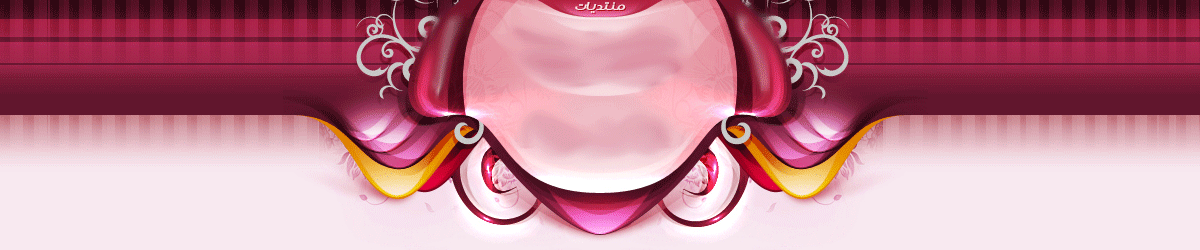عندما مدت مراسلة قناة «أنطينا تريس» الإسبانية المايكروفون إلى الممثلة السينمائية الإسبانية فيكتوريا أبريل فوق البساط الأحمر لمهرجان مراكش السينمائي، وسألتها عن «الصناعة» السينمائية المغربية، أجابتها «أبريل» بابتسامتها الواسعة: «إنهم (أي نحن المغاربة) يعيشون في نفس الفترة التي عشناها نحن في إسبانيا خلال الثمانينيات». أي أننا في المغرب، ورغم المهرجان السينمائي المنظم وفق أحد المقاييس العالمية، لا زلنا -حسب فيكتوريا- متخلفين عن إسبانيا بحوالي ثلاثين سنة.
المهم أن الذين دعوا فيكتوريا إلى الحلول كضيفة على مهرجان مراكش السينمائي، يجب أن يعرفوا أن هذه الممثلة بمجرد ما عادت إلى مدريد وقعت إلى جانب المخرج «ألمودوفر» (المظفر بالعربية) الذي يشغلها في أفلامه، بالإضافة إلى «خابيير بارديم»، الذي تمت دعوة أخيه قبل سنة إلى مهرجان سينمائي بطنجة أشهر فيه راية البوليساريو، ومثقفين إسبان آخرين، على رسالة مرفوعة إلى الملك الإسباني خوان كارلوس تطالبه بالتدخل لدى ملك المغرب من أجل إعادة «أميناتو حيدر» إلى المغرب.
فهذه هي طريقة «فيكتوريا أبريل» الخاصة في شكر المنظمين المغاربة الذين دعوها إلى حضور مهرجان مراكش السينمائي كضيفة.
شخصيا، لم أستغرب موقف هذه الممثلة المعادي لوحدة المغرب، فالأغلبية الساحقة من الممثلين السينمائيين والمسرحيين والصحافيين الإسبان لديهم نفس العداء المقيت لوحدة المغرب الترابية، خصوصا أولئك الذين عاشوا، عبر التلفزيون، الانسحاب المهين للجيش الإسباني من الصحراء دون قدرة على إطلاق رصاصة واحدة، بعد إعطاء الحسن الثاني الأمر لثلاث مائة وخمسين ألف مغربي بالزحف على الصحراء.
وبالإضافة إلى عقدة حرب أنوال التي كبد فيها المجاهد الكبير عبد الكريم الخطابي الجيش الإسباني أكبر هزيمة عسكرية في تاريخه، يشكل انسحاب الجيش الإسباني من الصحراء بدون مقاومة أمام جيش من المواطنين العزل إلا من المصاحف والرايات، عقدة إضافية ظلت راسخة في الوجدان القومي الإسباني إلى الآن.
ما هو الدرس الأول الذي نستخلصه من وضع «فيكتوريا أبريل» لتوقيعها على الرسالة المطالبة بتدخل ملك إسبانيا لدى ملك المغرب من أجل إعادة أميناتو إلى المغرب. ببساطة، نستخلص أنه من حق جميع الممثلين والنجوم أن يكون لهم موقف معادٍ لوحدة المغرب الترابية، لكن من حقنا أيضا أن نطالب بالاستغناء عن استدعاء أمثال هؤلاء إلى مهرجاناتنا السينمائية لكي يناموا ويأكلوا ويسافروا على حسابنا، وفي الأخير «يقلزوا» لنا بمجرد ما يعودون إلى بلدانهم.
هؤلاء الممثلون يستغلون نجوميتهم وعالميتهم لكي يدافعوا عن قناعاتهم السياسية ويستعملون وسائل إعلامهم لترويجها، فهل سمعنا نحن في المغرب بأن جهة ما في الإعلام العمومي حاولت استغلال وجود كل هؤلاء النجوم السينمائيين العالميين في مراكش لاستصدار موقف صغير أو تصريح بسيط من ممثل أو مخرج عالمي لصالح قضيتنا الوطنية الأولى، نستطيع نحن أيضا أن نرد به على هذه الحملة العالمية المنظمة ضد المغرب ووحدته.
لا شيء من هذا حدث. مجرد ثرثرة تافهة حول ممثلين عالميين يحبون في المغرب «حريرته» (وحريرة نيت) و«بسطيلته» و«طنجيته». مخرجون عالميون من كل بقاع العالم، أوربيون وأمريكيون وآسيويون، جميعهم موجودون في مراكش، ومع ذلك لا توجد لدينا خطة سينمائية لجعل هؤلاء النجوم يأخذون نبذة ولو بسيطة عن القصة الحقيقية لمشكلة الصحراء. لا أحد فكر، مثلا، في أن يشتغل مخرجون مغاربة بالاتفاق مع المركز السينمائي المغربي على إخراج فيلم قصير أو شريط حول الصحراء المغربية يتم عرضه على هامش المهرجان. وإذا نجح هذا الشريط في تغيير فكرة ممثل أو مخرج عالمي أو مجرد ضيف من ضيوف المهرجان، فسنكون قد كسبنا صوتا إلى جانبنا في هذه المعركة.
المشرفون على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية العالمية ينسون أن السينما هي إحدى الواجهات الأساسية في حرب الشعوب للدفاع عن حدودها وهويتها ومقوماتها اللغوية والثقافية والدينية. ومن يشك في ذلك ما عليه سوى أن يشاهد أفلام المخرج الأمريكي «سبايك لي»، وخصوصا فيلمه «معجزة في سانت آن»، حيث تبدأ الرموز الدينية المسيحية من «الجينريك» المليء بالصلبان إلى عمق القصة التي تدافع عن الإيمان المسيحي وتجعله الخلاص الوحيد للإنسان الباحث عن الحقيقة. ومع ذلك، لم نسمع نقادا سينمائيين في أمريكا يتهمون «سبايك لي» بالأصولية المسيحية أو التطرف الديني، بل إنه واحد من أهم وأكثر المخرجين السينمائيين إثارة للاحترام.
ولعل أكبر درس في احترام اللغة الأم هو ذلك الدرس الذي أعطاه المخرج الإيراني «عباس كيروستامي»، الذي أعلن عن افتتاح الدورة الحالية للمهرجان السينمائي الدولي بمراكش باللغة الفارسية.
هذا في الوقت الذي لم يحسم فيه بعد كثير من المخرجين السينمائيين المغاربة قضية اللغة في أفلامهم. وهكذا، نعثر على أفلام بالفرنسية مترجمة كتابة إلى العربية، وأفلام بدارجة «مدرحة» بالفرنسية، وثالثة لا أحد يعرف إلى الآن على أي صنف لغوي يحسبها.
ولعل مخرجي الفيلم الذي يمثل به المغرب في المسابقة الرسمية للمهرجان يعطينا فكرة واضحة حول هذا اليتم اللغوي الذي تعاني منه السينما المغربية، فقد رفضا الحديث أمام الصحافيين بالعربية، واشترطا الحديث بالفرنسية أو الإنجليزية، مع أن لغتهما الأم هي الإسبانية بحكم أن والدتهما إسبانية. وهما معذوران في ذلك، لأن والدهما المخرج حكيم النوري، الذي جاء إلى الإخراج من الديوانة، لم يعلمهما اللغة العربية منذ الصغر. وطبيعي، إذن، أن يأتي فيلمهما مفككا وغير مفهوم، إذ كيف سيستطيع مخرج سينمائي أن يصنع قصة مغربية ويقنع بها جمهورا مغربيا يجهل لغته وثقافته. أكثر من ذلك، فالمخرجان العبقريان ضمنا فيلمهما جملة في الحوار يقول فيها أحد «الأبطال» (الذي ليس سوى أخ رضا بنشمسي مدير «تيل كيل») إن الله ليس مستعدا لسماع شكواه لأنه (تعالى) مشغول بعزلته). «وشوفو التفلسيف ديال جوج دريال».
لذلك فالسينما المغربية مدعوة إلى التعلم من التجربة السينمائية الإيرانية. ليس فقط على مستوى الاعتزاز باللغة الأم (سواء كانت عربية أو أمازيغية) وإنما أيضا على مستوى استعمال السينما كواجهة للدفاع عن خصوصيات وثوابت وهوية البلد الذي ننتمي إليه.
في عهد الخميني، الذي يحلو لكثيرين تصويره كفقيه متعصب ومنطوٍ على نفسه، أعطى هذا الأخير أوامره لبناء أكثر من ستة آلاف مدرسة للسينما في مختلف ربوع إيران. ومن هذه المدارس تخرج مئات المخرجين السينمائيين والمصورين والممثلين وسائر ممتهني الصناعة السينمائية. وهكذا، أصبحت السينما الإيرانية واحدة من أهم المدارس السينمائية في العالم، تنتج سنويا مائة فيلم، تراجعت اليوم، بسبب الأزمة، إلى حوالي ستين فيلما في السنة.
ومن هذه المدارس تخرج «عباس كيروستامي» و«بهرام بيازاي» و«عامر نادري» و«محسن ماخمالباف» الذي كان في الأصل فقيها، ثم تخرجت ابنته «سميرة ماخمالباف» وغيرها من المخرجين الشباب الذين حملوا المشعل السينمائي الذي أوقده الخميني.
والمثير في السينما الإيرانية أن مخرجيها يحصدون الجوائز العالمية بأفلامهم في أي مكان يذهبون إليه في العالم، دون أن تحتوي أفلامهم على لقطة جنس واحدة. وليس غطاء الرأس الذي تضعه «سميرة ماخمالباف» هو الذي سيمنعها من تصوير أفلام جميلة وذات بعد إنساني. عندما أرى هذه المخرجة المحجبة وهي تصور أفلامها الرائعة، أفكر في كل أولئك المخرجات المغربيات اللواتي يعتقدن أن «بوطهن» العاري هو الذي سيشفع لهن في صناعة أفلام تستحق المشاهدة.
هذه المفارقة يجب على مخرجينا المغاربة أن يتأملوها جيدا. هم الذين لم يعودوا يستطيعون تصوير فيلم إلا ويظهر فيه ممثل وممثلة يمارسان الجنس كما حدث في فيلم «حجاب الحب»، أو ممثل وممثل يمارسان الشذوذ كما وقع في فيلم «لحظة ظلام»، أو ممثل يمارس العادة السرية كما صنع «الروخ» في فيلم «كازانيغرا». المصيبة أن كل هذا «الكبت السينمائي» صور على حساب أموال دافعي الضرائب.
واضح أن السينما المغربية على عهد نور الدين الصايل تعيش مراهقة سينمائية متأخرة تشبه كثيرا «عودة الشيخ إلى صباه». فقد أصبحت، في عهده، قصص الجنس والشذوذ موضوعات أساسية في السينما الوطنية، إلى الحد الذي أصبح معه كل مخرج يحمل مشروعا سينمائيا وطنيا يدافع عن هوية المغاربة وثقافتهم ودينهم شخصا مشبوها يحمل مشروعا أصوليا متطرفا تجب محاربته وقطع الطريق عليه.
إن الدرس العميق الذي يجب على ممثلينا ومخرجينا أن يستفيدوا منه في مهرجان مراكش السينمائي، هو أنهم يمتلكون سلاحا خطيرا ومؤثرا اسمه السينما. سلاح يمكن أن يساهموا به في الدفاع عن الهوية والشخصية المغربية والقضايا الإنسانية العادلة. كما يمكن إذا لم يحسنوا استعماله، أو فقط بسبب باختيارهم للسهولة والسطحية، أن يساهموا في تدمير القيم الأخلاقية والدينية والوطنية لأجيال كاملة من المغاربة.
فهل فهمتم الآن لماذا تصلح السينما؟
 بقلم رشيد نيني
بقلم رشيد نيني
المهم أن الذين دعوا فيكتوريا إلى الحلول كضيفة على مهرجان مراكش السينمائي، يجب أن يعرفوا أن هذه الممثلة بمجرد ما عادت إلى مدريد وقعت إلى جانب المخرج «ألمودوفر» (المظفر بالعربية) الذي يشغلها في أفلامه، بالإضافة إلى «خابيير بارديم»، الذي تمت دعوة أخيه قبل سنة إلى مهرجان سينمائي بطنجة أشهر فيه راية البوليساريو، ومثقفين إسبان آخرين، على رسالة مرفوعة إلى الملك الإسباني خوان كارلوس تطالبه بالتدخل لدى ملك المغرب من أجل إعادة «أميناتو حيدر» إلى المغرب.
فهذه هي طريقة «فيكتوريا أبريل» الخاصة في شكر المنظمين المغاربة الذين دعوها إلى حضور مهرجان مراكش السينمائي كضيفة.
شخصيا، لم أستغرب موقف هذه الممثلة المعادي لوحدة المغرب، فالأغلبية الساحقة من الممثلين السينمائيين والمسرحيين والصحافيين الإسبان لديهم نفس العداء المقيت لوحدة المغرب الترابية، خصوصا أولئك الذين عاشوا، عبر التلفزيون، الانسحاب المهين للجيش الإسباني من الصحراء دون قدرة على إطلاق رصاصة واحدة، بعد إعطاء الحسن الثاني الأمر لثلاث مائة وخمسين ألف مغربي بالزحف على الصحراء.
وبالإضافة إلى عقدة حرب أنوال التي كبد فيها المجاهد الكبير عبد الكريم الخطابي الجيش الإسباني أكبر هزيمة عسكرية في تاريخه، يشكل انسحاب الجيش الإسباني من الصحراء بدون مقاومة أمام جيش من المواطنين العزل إلا من المصاحف والرايات، عقدة إضافية ظلت راسخة في الوجدان القومي الإسباني إلى الآن.
ما هو الدرس الأول الذي نستخلصه من وضع «فيكتوريا أبريل» لتوقيعها على الرسالة المطالبة بتدخل ملك إسبانيا لدى ملك المغرب من أجل إعادة أميناتو إلى المغرب. ببساطة، نستخلص أنه من حق جميع الممثلين والنجوم أن يكون لهم موقف معادٍ لوحدة المغرب الترابية، لكن من حقنا أيضا أن نطالب بالاستغناء عن استدعاء أمثال هؤلاء إلى مهرجاناتنا السينمائية لكي يناموا ويأكلوا ويسافروا على حسابنا، وفي الأخير «يقلزوا» لنا بمجرد ما يعودون إلى بلدانهم.
هؤلاء الممثلون يستغلون نجوميتهم وعالميتهم لكي يدافعوا عن قناعاتهم السياسية ويستعملون وسائل إعلامهم لترويجها، فهل سمعنا نحن في المغرب بأن جهة ما في الإعلام العمومي حاولت استغلال وجود كل هؤلاء النجوم السينمائيين العالميين في مراكش لاستصدار موقف صغير أو تصريح بسيط من ممثل أو مخرج عالمي لصالح قضيتنا الوطنية الأولى، نستطيع نحن أيضا أن نرد به على هذه الحملة العالمية المنظمة ضد المغرب ووحدته.
لا شيء من هذا حدث. مجرد ثرثرة تافهة حول ممثلين عالميين يحبون في المغرب «حريرته» (وحريرة نيت) و«بسطيلته» و«طنجيته». مخرجون عالميون من كل بقاع العالم، أوربيون وأمريكيون وآسيويون، جميعهم موجودون في مراكش، ومع ذلك لا توجد لدينا خطة سينمائية لجعل هؤلاء النجوم يأخذون نبذة ولو بسيطة عن القصة الحقيقية لمشكلة الصحراء. لا أحد فكر، مثلا، في أن يشتغل مخرجون مغاربة بالاتفاق مع المركز السينمائي المغربي على إخراج فيلم قصير أو شريط حول الصحراء المغربية يتم عرضه على هامش المهرجان. وإذا نجح هذا الشريط في تغيير فكرة ممثل أو مخرج عالمي أو مجرد ضيف من ضيوف المهرجان، فسنكون قد كسبنا صوتا إلى جانبنا في هذه المعركة.
المشرفون على تنظيم هذه التظاهرة السينمائية العالمية ينسون أن السينما هي إحدى الواجهات الأساسية في حرب الشعوب للدفاع عن حدودها وهويتها ومقوماتها اللغوية والثقافية والدينية. ومن يشك في ذلك ما عليه سوى أن يشاهد أفلام المخرج الأمريكي «سبايك لي»، وخصوصا فيلمه «معجزة في سانت آن»، حيث تبدأ الرموز الدينية المسيحية من «الجينريك» المليء بالصلبان إلى عمق القصة التي تدافع عن الإيمان المسيحي وتجعله الخلاص الوحيد للإنسان الباحث عن الحقيقة. ومع ذلك، لم نسمع نقادا سينمائيين في أمريكا يتهمون «سبايك لي» بالأصولية المسيحية أو التطرف الديني، بل إنه واحد من أهم وأكثر المخرجين السينمائيين إثارة للاحترام.
ولعل أكبر درس في احترام اللغة الأم هو ذلك الدرس الذي أعطاه المخرج الإيراني «عباس كيروستامي»، الذي أعلن عن افتتاح الدورة الحالية للمهرجان السينمائي الدولي بمراكش باللغة الفارسية.
هذا في الوقت الذي لم يحسم فيه بعد كثير من المخرجين السينمائيين المغاربة قضية اللغة في أفلامهم. وهكذا، نعثر على أفلام بالفرنسية مترجمة كتابة إلى العربية، وأفلام بدارجة «مدرحة» بالفرنسية، وثالثة لا أحد يعرف إلى الآن على أي صنف لغوي يحسبها.
ولعل مخرجي الفيلم الذي يمثل به المغرب في المسابقة الرسمية للمهرجان يعطينا فكرة واضحة حول هذا اليتم اللغوي الذي تعاني منه السينما المغربية، فقد رفضا الحديث أمام الصحافيين بالعربية، واشترطا الحديث بالفرنسية أو الإنجليزية، مع أن لغتهما الأم هي الإسبانية بحكم أن والدتهما إسبانية. وهما معذوران في ذلك، لأن والدهما المخرج حكيم النوري، الذي جاء إلى الإخراج من الديوانة، لم يعلمهما اللغة العربية منذ الصغر. وطبيعي، إذن، أن يأتي فيلمهما مفككا وغير مفهوم، إذ كيف سيستطيع مخرج سينمائي أن يصنع قصة مغربية ويقنع بها جمهورا مغربيا يجهل لغته وثقافته. أكثر من ذلك، فالمخرجان العبقريان ضمنا فيلمهما جملة في الحوار يقول فيها أحد «الأبطال» (الذي ليس سوى أخ رضا بنشمسي مدير «تيل كيل») إن الله ليس مستعدا لسماع شكواه لأنه (تعالى) مشغول بعزلته). «وشوفو التفلسيف ديال جوج دريال».
لذلك فالسينما المغربية مدعوة إلى التعلم من التجربة السينمائية الإيرانية. ليس فقط على مستوى الاعتزاز باللغة الأم (سواء كانت عربية أو أمازيغية) وإنما أيضا على مستوى استعمال السينما كواجهة للدفاع عن خصوصيات وثوابت وهوية البلد الذي ننتمي إليه.
في عهد الخميني، الذي يحلو لكثيرين تصويره كفقيه متعصب ومنطوٍ على نفسه، أعطى هذا الأخير أوامره لبناء أكثر من ستة آلاف مدرسة للسينما في مختلف ربوع إيران. ومن هذه المدارس تخرج مئات المخرجين السينمائيين والمصورين والممثلين وسائر ممتهني الصناعة السينمائية. وهكذا، أصبحت السينما الإيرانية واحدة من أهم المدارس السينمائية في العالم، تنتج سنويا مائة فيلم، تراجعت اليوم، بسبب الأزمة، إلى حوالي ستين فيلما في السنة.
ومن هذه المدارس تخرج «عباس كيروستامي» و«بهرام بيازاي» و«عامر نادري» و«محسن ماخمالباف» الذي كان في الأصل فقيها، ثم تخرجت ابنته «سميرة ماخمالباف» وغيرها من المخرجين الشباب الذين حملوا المشعل السينمائي الذي أوقده الخميني.
والمثير في السينما الإيرانية أن مخرجيها يحصدون الجوائز العالمية بأفلامهم في أي مكان يذهبون إليه في العالم، دون أن تحتوي أفلامهم على لقطة جنس واحدة. وليس غطاء الرأس الذي تضعه «سميرة ماخمالباف» هو الذي سيمنعها من تصوير أفلام جميلة وذات بعد إنساني. عندما أرى هذه المخرجة المحجبة وهي تصور أفلامها الرائعة، أفكر في كل أولئك المخرجات المغربيات اللواتي يعتقدن أن «بوطهن» العاري هو الذي سيشفع لهن في صناعة أفلام تستحق المشاهدة.
هذه المفارقة يجب على مخرجينا المغاربة أن يتأملوها جيدا. هم الذين لم يعودوا يستطيعون تصوير فيلم إلا ويظهر فيه ممثل وممثلة يمارسان الجنس كما حدث في فيلم «حجاب الحب»، أو ممثل وممثل يمارسان الشذوذ كما وقع في فيلم «لحظة ظلام»، أو ممثل يمارس العادة السرية كما صنع «الروخ» في فيلم «كازانيغرا». المصيبة أن كل هذا «الكبت السينمائي» صور على حساب أموال دافعي الضرائب.
واضح أن السينما المغربية على عهد نور الدين الصايل تعيش مراهقة سينمائية متأخرة تشبه كثيرا «عودة الشيخ إلى صباه». فقد أصبحت، في عهده، قصص الجنس والشذوذ موضوعات أساسية في السينما الوطنية، إلى الحد الذي أصبح معه كل مخرج يحمل مشروعا سينمائيا وطنيا يدافع عن هوية المغاربة وثقافتهم ودينهم شخصا مشبوها يحمل مشروعا أصوليا متطرفا تجب محاربته وقطع الطريق عليه.
إن الدرس العميق الذي يجب على ممثلينا ومخرجينا أن يستفيدوا منه في مهرجان مراكش السينمائي، هو أنهم يمتلكون سلاحا خطيرا ومؤثرا اسمه السينما. سلاح يمكن أن يساهموا به في الدفاع عن الهوية والشخصية المغربية والقضايا الإنسانية العادلة. كما يمكن إذا لم يحسنوا استعماله، أو فقط بسبب باختيارهم للسهولة والسطحية، أن يساهموا في تدمير القيم الأخلاقية والدينية والوطنية لأجيال كاملة من المغاربة.
فهل فهمتم الآن لماذا تصلح السينما؟
 بقلم رشيد نيني
بقلم رشيد نيني